الحالات التي يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود للتصرفات التي تزيد قيمتها عن الحد المالي المعين بنظام الإثبات
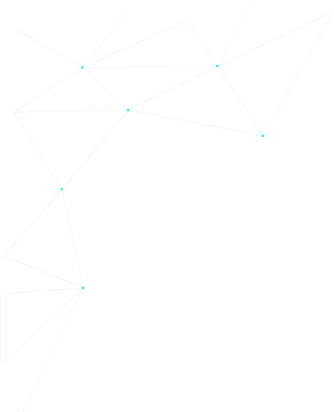

الحالات التي يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود للتصرفات التي تزيد قيمتها عن الحد المالي المعين بنظام الإثبات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد..
يُعد نظام الإثبات أحد المشاريع التشريعية الأربعة التي أعلن عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي صدر بموجب المرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ[1]، الذي يُعد تطوراً كبيراً في سبيل التقنين وتوحيد الاجتهاد القضائي وتحسين تمكين التنبؤ بالأحكام القضائية، وقد جاء النظام ببعض الأحكام التي تعتبر جديدة على البيئة النظامية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والتي منها وضع حد مالي معين لإثبات التصرفات بشهادة الشهود، والذي كان النظر القضائي مقتصر بالنسبة للإثبات بالشهادة في السابق على التحقق من أهلية الشاهد وكون ما يشهد عليه منتج في الدعوى بغض النظر عن قيمة هذه التصرفات المراد إثباتها، وهذا التوجه الجديد مأخوذ من القوانين الأخرى والتجارب الدولية.
وقد اتجه المنظم إلى تقييد الشهادة كوسيلة إثبات رئيسية نظرًا لما لوحظ من تزايد النزاعات المتعلقة بالشهادة غير الموثقة، ولتحقيق مزيد من الضبط القانوني في إثبات الحقوق، ولأهمية هذا الموضوع فسيكون محل بحثي هذا عن الحالات التي يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود لما زاد عن الحد المالي الذي وضعه المنظم، إذ أن المنظم قد جعل الأصل أن التصرفات لا يقبل إثباتها بشهادة الشهود إذا كانت قيمتها تزيد عن المائة ألف ريال سعودي؛ وعليه فسيكون البحث عن الحالات الاستثنائية لهذا الأصل.
الحالات المستثناة لإثبات التصرفات بشهادة الشهود بناءً على نظام الإثبات:
1. إذا كانت الشهادة على التصرف قبل نفاذ النظام:
وهذا مما يسري عليه قاعدة عدم رجعية الأنظمة، والأصل أن النظام لا يسري بأثر رجعي؛ وعليه فأي شهادة على تصرف كان قبل نفاذ النظام فالأصل أنها مقبولة ولو كانت قيمة التصرف أكثر من مائة ألف ريال.
فقد تضمنت ديباجة النظام ما نصه:
"خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.".
كما تضمنت المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على ما نصه:
"١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
٢- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.".
ومفهوم هذه المادة أن الشهادة على التصرفات التي كانت قبل سريان النظام لها حجتها النظامية؛ إذ كان النظام الذي كان سارياً في تلك الفترة قد أعطاها الحجية، وبالنظر إلى الأحكام المتعلقة بالإثبات في نظام المرافعات الشرعية فلم نجد أنه قيد الإثبات بالشهادة بقيمة معينة؛ وعليه يمكن الإثبات بشهادة الشهود لما زاد عن الحد المالي إذا كان التصرف قبل سريان النظام ووجد الشهود عليه في حينه،
والذي يؤكد هذا المفهوم ما جاء في شرح نظام الإثبات ونصه:
"وأما سريان النظام بشقيه الموضوعي والإجرائي من حيث الزمان فقد بينته المادة (3) من الأدلة الإجرائية؛ إذ أوضحت النطاق الزمني لسريان القواعد الموضوعية الواردة في النظام، وبينت أن المعتبر في أدلة الثبات وحجيتها هو الأحكام التي كان معمولاً بها وقت نشوء الوقائع أو التصرفات محل الإثبات؛ ولذا فإن القواعد الموضوعية الواردة في النظام بشأن أدلة الإثبات لا تسري إلا على الوقائع والتصرفات التي نشأت بعد نفاذ أحكامه".[2]
وأورد سابقة قضائية تؤكد هذا التصور؛ إذ تضمن تسبيب الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية ما نصه:
"الأسباب:
بما أن الدائرة قد حكمت بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى، وبما أن دائرة الاستئناف قد ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص وأعادت القضية للدائرة للنظر في موضوعها؛ فإن الدائرة تكون ملزمة بنظر موضوع الدعوى بناءً على المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعيين قد نص على طلبه في هذه الدعوى بما نصه:(الحكم بعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر وإخلاء سبيل موكلاي منه)، وبما أن الدائرة وبعد النظر في طلبات المدعى عليه ودفوعه يكون متحتمًا عليها الدخول في موضوع الشراكة وما آلت إليه؛ ليتبين بذلك حقيقة استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر من عدمه، لاسيما وقد قررت دائرة الاستئناف أن (السند لأمر مرتبط بالشراكة التجارية بناءً على العقد المبرم بين الطرفين، كما أن السند ممهور بختم الشركة). كما جاء في أسباب حكمها السابق، مما اقتضى معه اعتبار هذا السند لأمر متعلقا بالشراكة، ويكون استحقاق المدعى عليه له بعد انتهاء مدة الشراكة إذا لم يثبت وجود خسارة، وبما أن مدة الشراكة كانت سنة ميلادية واحدة ابتداءً من تاريخ ٢٥/ ٣/ ٢٠١٨م، وبما أن المدعى عليه قد قدم في سبيل إثبات عدم الخسارة وأن الأمر على خلاف هذا الادعاء شهادة عدد من الشهود، ومن ضمنها شهادة الشاهدين عبدالله صالح عبدالله الشهراني، وحسن محمد سعيد النجمي الزهراني، واللذان شهدا بأن المدعي قد وعد المدعى عليه بإعادة رأس ماله، وأن الشراكة قد نتج عنها أرباح تقدر بـ ٢٠% من رأس المال، وبما أن الدائرة لم يظهر لها ما يوجب رد شهادة الشهود لا سيما وهي شهادة على واقعة ناشئة قبل سريان نظام الإثبات، والأصل اعتبارها، استناداً على مبدأ عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي، بل قد نصت المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على ما يلي:(١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها. ٢- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحًا، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه)، الأمر الذي رأت معه الدائرة الأخذ بهاتين الشهادتين واعتبارهما، وأما دفع وكيل المدعي بالاستدلال بالقوائم المالية للشركة على أن المدعى عليه لا يستحق إلا مبلغاً قدره (٧٦٥.٩٢٥) سبعمائة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، فإن ذلك غير وجيه؛ لعدم تطابق المدة بين دخول المدعى عليه كشريك وبين ما ورد في القوائم المالية، كما أن الطريقة التي تم احتساب مبلغ المدعى عليه بناءً عليها غير صحيحة، إذ نص العقد على أن المدعى عليه شريك لمدة سنة ميلادية، وقد ابتدأت من تاريخ تحويله لمبلغ الشراكة في ٢٥/ ٣/ ٢٠١٨م؛ فلا يصح إدخاله في فترات سابقة أو لاحقة لم يكن هو شريكاً فيها كما تم احتسابها من قبل المدعي، فلا يستقيم هذا الاستدلال للمدعي؛ مما يتجه معه القول باستحقاق المدعى عليه لرأس ماله، والذي هو مبلغ مليون ريال، وهو ذات المبلغ المدوَّن في السند لأمر الممهور بختم الشركة، مما تكون معه الدعوى حريةً بالرفض. وأما ما يتعلق باستدلال وكيل المدعي بنظام الإثبات من كونه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة، ومن عدم قبول شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات في كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو ما يعادلها أو كان غير محدد القيمة، فإن ذلك غير متجه، لما سبقت الإشارة إليه مما ورد في المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى.
نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب."[3]
2. عدم حضور جلسة الاستجواب بغير عذر مقبول أو الامتناع عن الإجابة:
يُعد عدم حضور الخصم لجلسة الاستجواب أو الامتناع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر من الحالات التي يجوز للمحكمة قبول الإثبات بشهادة الشهود ولو زادت قيمة التصرفات عن المائة ألف.[4]
ويعلل ذلك حث الخصم المستجوب على الحضور والإجابة وتلافياً لتأخير الفصل في الدعاوى.[5]
3. عدم حضور المدعى عليه في جلسة سماع الدعوى أو الامتناع عن الإجابة عن الدعوى:
تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة سماع الدعوى أو الحضور ثم الامتناع عن الإجابة عليها يعد من الحالات التي يجوز للمحكمة قبول الإثبات بشهادة الشهود ولو زادت قيمة التصرفات عن المائة ألف.[6]
ويعلل ذلك بألا يتخذ المدعى عليه عدم الحضور وسيلة لتأخير الفصل في الدعوى وحجب المحكمة عن الوصول إلى أدلة الإثبات التي كان بإمكانها الوصول إليها بحضوره.[7]
4. في حال وجود اتفاق على الإثبات بالشهادة:
تضمنت المادة السادسة والستون من نظام الإثبات على أن الأصل أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال، ولا تقبل شهادة الشهود في إثبات التصرفات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.[8] ويجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً.[9]
5. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة:
عرَّف المنظم مبدأ الثبوت بالكتابة أنه: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.[10]مثل الدفاتر التجارية والأوراق الخاصة وغيرها من أنواع الكتابة التي تجعل المدعى به قريب الاحتمال.[11]
فإذا ثبت أصل التصرف بدليل كتابي ناقص غير تام الدلالة على محل الدعوى مما تجعل المدعى به قريب الاحتمال؛ فيجوز في هذه الحالة تقوية إثبات التصرف بالشهادة ومثاله الرسائل المتبادلة بين الخصوم في حال تم الإشارة فيها إلى وجود عقد بيع بين الطرفين دون تحديد المبيع أو ثمنه؛ فهُنا وُجد مبدأ الثبوت بالكتابة ويتم إثبات المبيع وثمنه بشهادة الشهود ولو زادت قيمة التصرف على الحد المالي.[12]
6. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي:
أولًا: تعريف المانع المادي والأدبي:
يُقصد بالمانع المادي أو الأدبي؛ الظروف التي تجعل من غير الممكن أو غير المناسب للمدعي الحصول على دليل كتابي عند إجراء التصرف القانوني.
ويعود السبب في ذلك إلى أن بعض الظروف قد تمنع تحرير مستندات رسمية أو توثيق التصرف بالكتابة؛ مما يجعل اشتراط الدليل الكتابي أمرًا غير منصف في هذه الحالات.
ثانيًا: أنواع الموانع وأثرها في قبول الشهادة:
· المانع المادي:
يشمل جميع الحالات التي يكون فيها من المستحيل عمليًا أو واقعياً الحصول على مستند كتابي يوثّق التصرف القانوني.
أمثلة على ذلك:
إبرام تصرف قانوني في ظروف استثنائية طارئة، مثل وقوع الصفقة في منطقة نائية أو أثناء سفر حيث لا تتوفر وسائل الكتابة.
التعاقد في ظل ظروف قهرية تمنع توثيق المعاملة، مثل حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية التي تعيق الوصول إلى وسيلة إثبات كتابية.
· المانع الأدبي:
ينشأ عندما تكون طبيعة العلاقة بين الأطراف تجعل من غير المعتاد أو غير اللائق المطالبة بتحرير مستند كتابي عند إجراء التصرف القانوني.
أمثلة على ذلك:
التصرفات التي تتم بين الأقارب من الدرجة الأولى، مثل القروض والهبات التي تُعطى بين الأب وابنه، أو بين الإخوة، حيث يُعتبر طلب توثيق كتابي أمرًا غير مألوف اجتماعيًا.
الاتفاقات التي تُبرم بين الأشخاص الذين تربطهم علاقة ثقة خاصة، مثل تصرفات بين الأزواج، أو بين الأصدقاء المقربين، حيث يكون من غير المألوف أو المقبول اشتراط مستند كتابي.
التعاملات التي تكون قائمة على الحياء الاجتماعي، مثل قبول شخص لوديعة أو أمانة من شخص آخر دون توثيق كتابي نظرًا لطبيعة العلاقة بينهم.
ثالثًا: كيفية إثبات وجود المانع:
يقع على عاتق المدعي إثبات وجود المانع المادي أو الأدبي الذي حال دون الحصول على دليل كتابي.
للقاضي سلطة تقديرية في تقييم مدى مشروعية المانع والقبول بالإثبات بالشهادة بناءً على قرائن الأحوال وطبيعة العلاقة بين الأطراف.
7. فقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه:
أولًا: مفهوم فقدان الدليل الكتابي:
يُقصد بهذه الحالة أن يكون المدعي قد حصل بالفعل على دليل كتابي يوثّق التصرف القانوني، لكنه فقده بسبب ظروف خارجة عن إرادته، مما يستوجب منحه الحق في اللجوء إلى الإثبات بشهادة الشهود لتعويض هذا الفقد.
ثانيًا: أمثلة على حالات فقد الدليل الكتابي:
أ- الفقد بفعل القوة القاهرة أو الحوادث غير المتوقعة:
· احتراق أو تلف المستندات بسبب حريق، أو زلزال، أو فيضان.
· سرقة أو ضياع المستندات في ظروف لا يمكن للمدعي السيطرة عليها.
· تلف السجلات بسبب عوامل الزمن أو الإهمال غير المقصود أو القرصنة الالكترونية.
ب-الفقد نتيجة أفعال الغير دون خطأ من المدعي:
· ضياع الأوراق في إجراءات حكومية أو مصرفية دون إهمال من المدعي.
· فقدان المستند بسبب تصرف غير مشروع من الخصم (مثل إتلافه عمدًا من الطرف الآخر لإخفاء دليل ضدّه).
ثالثًا: كيفية إثبات وقوع الفقد:
يجب على المدعي تقديم ما يثبت أنه كان بحوزته الدليل الكتابي بالفعل، مثل:
· نسخة غير رسمية أو صورة من المستند الأصلي.
· شهادة من جهة رسمية تُثبت وجود المستند قبل فقدانه.
· مراسلات أو أي قرائن أخرى تدل على وجود المستند قبل الفقد.
فأجاز نظام الإثبات قبول شهادة الشهود في حال فقد الدليل الكتابي بسبب قوة قاهرة أو حادث لا يد للمدعي فيه، بشرط تقديم قرائن تدعم ادعاءه.
ويُترك للقاضي سلطة تقدير مدى جدية الفقد ومدى موثوقية الشهادة كبديل للإثبات الكتابي.
ختامًا، يُعد الإثبات بشهادة الشهود من الوسائل التقليدية التي لعبت دورًا محوريًا في حسم النزاعات القانونية منذ القدم، ورغم التطور التشريعي الذي فرض الكتابة كوسيلة أساسية للإثبات، إلا أن الحاجة العملية فرضت وجود استثناءات تسمح بقبول الشهادة في بعض الحالات.
وقد استعرض هذا البحث تحليلًا للحالات الاستثنائية لقبول الشهادة لإثبات التصرفات التي تزيد عن الحد المالي وبناءً على البحث؛ يمكن القول إن التطورات التشريعية في هذا المجال تحتاج إلى مراجعة دورية لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، فضلًا عن ضرورة نشر التطبيقات القضائية لتوضيح كيفية تطبيق الاستثناءات في الواقع العملي. نسأل الله أن يكون هذا البحث قد أسهم في توضيح الجوانب المهمة لموضوع الإثبات بالشهادة في التصرفات القانونية، وأن يكون إضافة مفيدة للمكتبة القانونية والبحثية.
والله ولي التوفيق..
عبدالله بن تركي الحمودي
[1] نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) لعام 1443هـ.
[2] شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل المملكة العربية السعودية، الإصدار الأول، 1446هـ - 2024م ص 14.
[3] القضية رقم ٤٢٨٥٩٨ لعام ١٤٤٤ هـ، منصة محاكمة.
[4] الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات.
[5] شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل المملكة العربية السعودية، ص 71.
[6] الفقرة (3) من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات.
[7] شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل ص 71.
[8] الفقرة (2) من المادة السادسة والستون من نظام الإثبات.
[9] المادة السادسة من نظام الإثبات.
[10] الفقرة (2) من المادة الحادية والخمسون من نظام الإثبات.
[11] شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل ص 170.
[12] شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل ص 171.